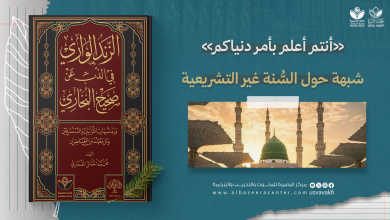قال تعالى: (مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ). فما الحاجة إلى السنة النبوية؟
خلاصة الشبهة: أنَّ الله تعالى ذكر في كتابه كلَّ شيءٍ يُحتاج إليه من أمور الديانة، وهو وافٍ بأصول أحكام الدين، قد فصَّلها تفصيلًا لا يحتاج إلى شرح ولا إلى تفسير؛ لقوله تعالى: (مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ) [الأنعام: 38]،وبناء عليه فلا حاجة إلى السُّنَّة؛ لأنَّ القرآن قد اشتمل على ما فيها وزاد عليه.
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:
الوجه الأول: أن «الكتاب» في قوله تعالى: (مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ) [الأنعام: 38] هو اللوح المحفوظ؛ لأنه الذي حَوَى عِلمَ كلِّ شيءٍ وتفصيلَه، واشتمل على جميع أحوال المخلوقات على التَّفصيل التَّام، وهو اختيار أكثر العلماء.
ويشهد لهذا القول سياق الآية، فإنه قال قبلها: ﵟوَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰٓئِرٖ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُمۚﵞ [الأنعام: 38]، وهذا يتضمَّنُ أنها أُمَمٌ أمثالُنا في الخَلْقِ والرِّزق والأكل والتَّقدير، قد قدَّر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه، فلا يناسب هذا ذِكْر كتاب الأمر والنهي، وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول. وعلى هذا فلا حجة في الآية.
الوجه الثاني: أنَّ المراد بالكتاب القرآن، فيكون المعنى: ما فرطنا في شيءٍ يُحتاج إليه في أمر الدِّين إلَّا وبيَّناه في الكتاب؛ إمَّا نصًّا، وإمَّا مجملًا، وإمَّا دلالةً، فهو من العام المراد به الخاص.
قال عبد الله بن محمد الفريابي: «سمعت الشافعي بمكة يقول: سلوني عما شئتُم أخبركُم من كتاب الله وسُنَّة نبيه ﷺ، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في المُحْرِم قَتلَ زُنْبورًا؟ فقال: قال الله تعالى: (وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ) [الحشر: 7]، وحدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عُمير، عن رِبْعِي بن حِراش، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ:«اقْتَدُوا باللَّذَيْنِ مِن بَعْدي أبي بكر وعُمَر» 1، وحدثنا سفيان، عن مِسْعَر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عُمَر أنه أمر بقتل الزنبور».
وفي حديث العسيف الزاني أنَّ أباه قال للنبي ﷺ: اقض بيننا بكتاب الله، فقال عليه الصلاة السلام: «والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله»، ثم قضى بالجَلْدِ والتَّغريب على العسيف، وبالرَّجم على المرأة إن اعترفت. [أخرجه البخاري ومسلم].
قال الواحدي: «وليس للرجم والتَّغْرِيب ذِكْرٌ في نصِّ الكتاب، فجعلهما النبي ﷺ من الكتاب لَمَّا حكم هو بهما، وهذا يبين لك أن كل ما يحكم به النبي ﷺ كان ذلك كما لو حكم به الكتاب نصًّا».
الوجه الثالث: أنَّ المقصود من إنزال هذا الكتاب بيانُ الدِّين، ومعرفةُ الله، ومعرفةُ أحكام الله، غير أنَّ هذا البيانَ يكون تارةً بالنصِّ؛ كوجوب الصلاة والزكاة، وتحريم الزنا والخمر، وتارةً بالإجمال والإحالة على سُنَّة النبي ﷺ؛ كعدد الصلاة والزكاة ووقتها، فإنَّ النبي ﷺ مبيِّنٌ للتنزيل بقوله وفِعله، كما ثبت بنصِّ القرآن الكريم.
وادِّعاءُ أنَّ القرآن الكريم نصَّ على كلِّ جزيئةٍ من جزئيات الدين، وأحاط بكل فرعٍ من فروعه ادِّعاءٌ باطلٌ، لم يقل به أحدٌ من علماء المسلمين، وهو افتراءٌ يردُّه الواقع، فأين نجدُ في القرآن عدد الصلوات الخمس، وعدد ركعاتها، وصفاتها من سِرٍّ وجَهرٍ وقيامٍ وركوعٍ وسجودٍ وتكبير؟
إنَّ كل حُكمٍ لم يُبيَّن في القرآن على وجه التَّفصيل يُتلقَّى بيانُه من الرسول ﷺ، أو من الإجماع، أو من القياس، أو غيرها من الأصول المعتبرة، التي أرشد إليها الكتاب العزيز.
قال الشافعي: «فكُل من قَبِل عن الله فرائضه في كتابه قَبِل عن رسول الله سُنَّنه بفرض الله طاعةَ رسولِه على خَلْقِه، وأنْ يَنْتَهوا إلى حُكمه، ومَن قَبِل عن رسول الله فعَنِ الله قَبِل؛ لِمَا افترض الله مِن طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسُنَّة رسول الله القبول لكل واحدٍ منهما عن الله».
الوجه الرابع: أنَّ الكتاب الذي يزعمون الاكتفاء به فَرَضَ اتِّباعَ الرسول ﷺ، وجعله هو المبيِّنَ عن الله سبحانه؛ كما في قوله تعالى: (وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ) [النحل: 44]، وقوله: (وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ) [النحل: 64].
ولا معنى لتبيين الكتاب إلا تفصيل مُجمَلِه، وتفسير مُشْكِلِه، وغير ذلك من مسائل الدين التي لم يتناولها الكتاب بالنَّص.
وأمر بطاعته فقال سبحانه: (أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ) [النساء: 59]، وطاعة الله لا شك بالرجوع إلى كتابه، وطاعة الرسول بالرجوع إلى سُنَّته، ولو كان المراد الكتاب وحده لما كان ثَمَّتَ داعٍ للتكرار.
وأوجب الأخْذَ بكل ما جاء به، فقال جلَّ وعلا: (وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ ) [الحشر: 7].
وصرح بأنَّ طاعته طاعةٌ لله، فقال تعالى: (مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ) [النساء: 80].
وأوعد المخالفين لأمره، والمتجافين عن حكمه، بالفتنة والعذاب الأليم، فقال عز من قائل: (فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: 63].
وأمرهم بالرجوع إلى سُنَّته عند التنازع، فقال تعالى: (فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ) [النساء: 59]، أي: رُدُّوا ذلك الحُكْمَ إلى كتاب الله أو إلى رسوله ﷺ بالسُّؤال في حياته، أو بالنظر في سُنَّته بعد وفاته.
وجعل اتِّباع الرسول ﷺ بابًا لمحبة الله لهم، فقال عز من قائل: (قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ) [آل عمران: 31].
- [أخرجه الحاكم وابن حبان والترمذي وحسَّنه] ↩︎